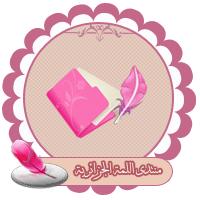أبو حذيفة الجزائري
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 31 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 74
- نقاط التفاعل
- 0
- نقاط الجوائز
- 1
- آخر نشاط
في حكـم الاشتراك في الأضحية
السؤال:
ما حُكمُ الشرعِ في الاشتراك في الأضحية سواءً من حيث الثمنُ أو من حيث الثوابُ، وذلك في البَدَنَة والبقرة والشياه، خاصّة وأنّ حديث جابر رضي الله عنه يتكلَّمُ عن البدنة والبقرة فقط؟
-هل تَمَّ الاشتراك في الأُضحية في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خاصّة الشاة ؟
- هل أجمع العلماء خاصّة الأئمّة الأربعة على عدم الاشتراك في الشاة مثل ما جاء في بداية المجتهد(١- (1/420))؟
- هل تكلَّم العلماءُ في الاشتراك في الشاة ممَّن كانت تجمعهم نفقةٌ واحدة أي أنّ ربّ البيت يأخذ كلّ شهر نصيبًا من ابنه للنفقة على البيت وحين يحلُّ العيد يفعل كذلك في شراء الشاة؟
- هل يصحُّ الاستدلال بحديث مِخْنَف بن سُلَيم رضي الله عنه: «كُنَّا وُقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍّ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً»(٢- أخرجه أبو داود في «الأضاحي» باب باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (2788)، والترمذي في «الأضاحي» (1518)، والنسائي في «الفَرَع والعتيرة» باب الفرع والعتيرة (4222)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني) (1478))، وسنده حَسَنٌ عند بعض العلماء إلاَّ أننا سمعنا أنه ضعيف على هذا المنوال، وإنما الصحيح قوله ابتداءً من: «عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ…».
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالاشتراكُ في البَدَنة والبقرة جائزٌ لِمَا أخرجه الخمسةُ إلاَّ أبا داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كُنّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَذَبَحْنَا البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ»(٣- أخرجه الترمذي في «الحجِّ» باب في الاشتراك في البدنة والبقرة (905)، والنسائي في «الضحايا» باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا (4392)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ (3131)، وأحمد (2480)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/410)، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: «جميع رجاله ثقات» (9/304)، وصحّحه الألباني في «المشكاة» (1469))، والحديث يَدُلُّ على جواز الاشتراك بالعدد المخصوص سبعة أنفار للبقرة، وعَشْرُ أنفس للبَدَنة، ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: «أنّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ»(٤- أخرجه البخاري في «الشركة» باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم (2324)، ومسلم في «الأضاحي» (5093)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه)، أمَّا الشاة ففي الاشتراك فيها محلُّ خِلافٍ بين أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الشاة لا تجزئ إلاَّ عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيرِه من أهل العلم، وقد ادَّعى كُلٌّ مِن ابنِ رُشْدٍ والنووي الإجماع على ذلك، وهو إجماعٌ مُنْتَقَضٌ بما حكاه الترمذي في سُنَنِه أنَّ الشاة تجزئ عن أهل البيت، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق واحتجَّا بحديث جابر رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ: هَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»(٥- أخرجه أبو داود في «الضحايا» (2810)، والترمذي في «الأضاحي» (1521)، والحاكم (7553)، وأحمد (14477)، والبيهقي (19720)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسّنه ابن حجر في «المطالب العالية» (3/32)، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (4/394)).
وأصحُّ الأقوال أنَّ الشاة تجزئ عن المضحِّي وأهل بيته لما رواه ابن ماجه والترمذي وصحّحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى»(٦- أخرجه الترمذي في «الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (1505)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب من ضحى بشاة عن أهله (3147)، ومالك في «الموطإ» (1040)، والبيهقي (19526)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء» (1142))، غير أنّ المضحِّيَ يحصل على الثواب أصالةً وأهلَ بيته تجزئهم بالتَّبَعِ، ودليله حديث رافع بن خديج وحديث ابن عباس رضي الله عنهم ففيهما دلالة واضحة أنَّ البعير يجزئ عن العشرة بذواتهم وأعيانهم حقيقة إذ ليس مقرونًا بلفظ أهل البيت المذكور في حديث أبي أيوب السابق، فإنّ ذلك يفيد دخولَهم بالتبع والإضافة لا بالأصالة والحقيقة، ويؤيِّد ما ذكرنا أنّ الزوجة مثلاً لو تَمَتَّعت بالحجِّ أو قرنت لَمَا يكفي هدي زوجها في الإجزاء عنها، فَدَلَّ على أنّ إجزاءه في الأضحية ليس بالأصالة، وثواب الأصيل فوق ثواب التابع كما لا يخفى.
أمّا حديث مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر، قال الخطابي: هو مجهول والحديث ضعيفُ المَخرج(٧- انظر: «معالم السنن» للخطابي: (3/226))، وقال أبو بكر بن العربي المالكي: «حديث مخنف بن سليم ضعيف فلا يحتجّ به»(٨- عارضة الأحوذي لابن العربي: (6/304))، كما ضعّفه عبد الحقّ وابن القطان لعلّة الجهل بحال أبي رملة، ورواه عنه ابنه حبيب بن مِخنف وهو مجهول أيضًا(٩- انظر: «نصب الراية» للزيلعي: (4/211))، وقد رواه من هذا الطريق عبد الرزاق في «مصنّفه»، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في «معجمه» بسنده، والبيهقي في «المعرفة» لذلك حسّنه الألباني في «صحيح أبي داود»(١٠- «صحيح أبي داود»: (2/183) رقم (2788)) وفي «صحيح سنن الترمذي»(١١- «صحيح سنن الترمذي»: (2/165) (1518)) وفي«صحيح ابن ماجه»(١٢- «صحيح ابن ماجه»: (3/82) (2550)).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 7 ذو الحجة 1417ﻫ
الموافق ﻟ: 15 أفريل 1997م
١- (1/420).
٢- أخرجه أبو داود في «الأضاحي» باب باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (2788)، والترمذي في «الأضاحي» (1518)، والنسائي في «الفَرَع والعتيرة» باب الفرع والعتيرة (4222)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني) (1478).
۳- أخرجه الترمذي في «الحجِّ» باب في الاشتراك في البدنة والبقرة (905)، والنسائي في «الضحايا» باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا (4392)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ (3131)، وأحمد (2480)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/410)، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: «جميع رجاله ثقات» (9/304)، وصحّحه الألباني في «المشكاة» (1469).
٤- أخرجه البخاري في «الشركة» باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم (2324)، ومسلم في «الأضاحي» (5093)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.
٥- أخرجه أبو داود في «الضحايا» (2810)، والترمذي في «الأضاحي» (1521)، والحاكم (7553)، وأحمد (14477)، والبيهقي (19720)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسّنه ابن حجر في «المطالب العالية» (3/32)، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (4/394).
٦- أخرجه الترمذي في «الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (1505)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب من ضحى بشاة عن أهله (3147)، ومالك في «الموطإ» (1040)، والبيهقي (19526)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء» (1142).
۷- انظر: «معالم السنن» للخطابي: (3/226).
۸- عارضة الأحوذي لابن العربي: (6/304).
٩-انظر: «نصب الراية» للزيلعي: (4/211).
١٠- «صحيح أبي داود»: (2/183) رقم (2788).
١١- «صحيح سنن الترمذي»: (2/165) (1518).
١٢- «صحيح ابن ماجه»: (3/82) (2550).
آخر تعديل: