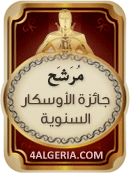شَهْرُ شَعْبَانَ.. حِكَمٌ وأَحْكَامٌ(1)
الحمدُ لله الذي جعلَ لعبادِه مَواسمَ يَسْتكثرون فيها مِن القُرُبات والعملِ الصَّالح، وأَمَدَّ في آجالهم فهُم في أَبوابِ الخَيْرِ بين غادٍ ورائِح، ومِن هذه المَواسم المُبارَكات، التي على المسلمِ أنْ يَغْتنمها لِزَرْع الطَّاعات، والتَّزوُّد بالباقِيات الصَّالحات: شهر شَعبان. وفي هذا المقال تَذْكير بفَضْل هذا الشَّهر، الذي يَغْفُل عنه كثير مِن النَّاس، كما أَخْبرنا بذلك نَبيُّنا صلى الله عليه وسلم، وهذا لِنَسْتعِدَّ له بالاجتهاد في الطَّاعة، اقْتداءً بنَبيِّنا وقُدْوتنا صلى الله عليه وسلم، وللإكثار فيه مِن الصِّيام؛ لأنَّ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»(2).
وقَبْل الشُّروع في المَطْلوب، أُقدِّم ـ بين يدَي المَوضوع ـ ذِكْر ما قِيل في معنى هذا الشَّهر:
شَعْبان: اسمٌ للشَّهر المَعروف، الَّذي بين رَجَب ورَمَضان، وقِيل: سُمِّي (شعْبَان): لِتَشَعُّبهم فِيهِ، أَيْ: تَفَرُّقهم فِي طَلب المِيَاه(3).
وقِيل: سُمِّي كذلك: لِتَشَعُّب القبائل فيه(4)، أو لِتَشَعُّبهم في الغارات(5).
قال ثَعْلَب رحمه الله: «قال بعضهم: إنَّما سُمِّي شَعبانُ شعبانَ لأنَّه شَعَبَ، أيْ: ظهر بين شَهْرَيْ رَمضان ورَجَب»(6).
وقال ابن حجر رحمه الله: «وسُمِّي شَعبان: لِتَشَعُّبهم في طَلب المياه، أو في الغارات بعد أنْ يَخْرُج شَهْر رَجَب الحرام، وهذا أَوْلى مِن الذي قَبْله، وقِيل فيه غير ذلك»(7).
وقد يُقال ـ أيضًا ـ: إنَّه سُمِّي بذلك لِتَشَعُّب الخير فيه بالنِّسْبة للصَّائم، وهذا بِناءً على ما جاء في حديثٍ: أخرجه الرَّافعي في «تاريخه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مَرفوعًا: «إِنَّمَا سُمِّي شَعْبانَ؛ لأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ خَيْرٌ كثِيرٌ لِلصَّائِمِ فِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ الجَنَّةَ»، ولكنَّ هذا الحديث لا يَثْبُت(8).
وقد اخْتَرْتُ ـ في هذا المَقال ـ بعض الأحاديث الصَّحيحة الواردة في السُّنَّة المُطهَّرة، في أبواب مُتنوِّعة، ممَّا له صِلةٌ وعَلاقة بِشَهر شَعبان، وجَعلتها تَحْت أَبْواب مُناسِبة، كما تَرْجم لها أهل الحديث أو قَريبا مِن ذلك، ثُمَّ أَتْبعتها بذِكر ما حَوَته مِن حِكَم وأَحْكام، ممَّا هو مَبْثوث في شُرُوحات أهل العِلم، وهذا على وَجْه الاختصار والإيجاز، وأَسألُ الله تعالى أنْ يَنْفع به كاتِبه وقارِئه ﴿يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُون* إِلاَّ مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيم﴾[الشعراء: 88-89].
1 ـ فَضْل لَيلة النِّصْف مِن شَعبان:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ لاثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ»(9).
وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَطْلُعُ الله إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ»(10).
وعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اطَّلَعَ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ، فَيَغْفِرُ لِلمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلكَافِرِينَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ»(11).
قال الألباني رحمه الله: «وجُمْلة القَول أنَّ الحديث بمجموع هذه الطُّرق صحيح بلا ريب، والصِّحَّة تَثْبُت بأقلَّ منها عددًا، ما دامتْ سالمةً مِن الضَّعف الشَّديد، كما هو الشَّأن في هذا الحديث، فما نَقله الشَّيخ القاسمي رحمه الله في «إصلاح المساجد» (ص 107) عن أهل التَّعديل والتَّجريح: أنَّه ليس في فَضْل ليلة النِّصف مِن شعبان حديث صحيح، فليس ممَّا يَنْبغي الاعتماد عليه، ولئن كان أحدٌ منهم أَطلق مِثْل هذا القول فإنَّما أُوتي(12) مِنْ قِبَل التَّسرُّع وعَدم وسع الجُهد لِتَتبُّع الطُّرُق على هذا النَّحو الذي بين يَديك، والله تعالى هو المُوفِّق»(13).
ويَكفي هذه اللَّيلة المُباركة فَضْلا: أنَّ الله تعالى يَغْفر فيها لجميع خَلْقه إلاَّ لأهل الحِقْد والبَغْضاء والشَّحْناء، وفي هذا دَعْوة إلى العَفْو عن المُسيء والتَّجاوُز عنِ المُخْطئ، والجَزاء مِن جِنْس العَمل.
والمُشاحِن: هو المُعادي، والشَّحْناء: هي العَداوة. وقال الأَوْزاعي: «أَراد بالمُشاحِن ها هُنا: صاحِب البِدْعة، المُفارِق لجَماعة الأُمَّة» (14).
ولا يَفوتُني ـ بهذه المُناسبة ـ التَّنْبيه على أنَّه لم يَصِحَّ شَيء في فَضْل قِيام هذه اللَّيلة، إذْ كُلُّ ما ورد في ذلك لا يَسْلَم مِن ضُعْف، و ممَّا رُوي في هذا الباب: ما أَخرجه ابن ماجه (1388) والبَيْهقي في «شُعَب الإيمان» (3555) عَنْ عَلِيِّ ابنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ، أَلاَ كَذَا، أَلاَ كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»(15).
قال عليٌّ القاري رحمه الله: «واعْلَم أنَّ المَذكور في «اللَّآلي»: إنَّ مائة رَكعة في نِصف شَعْبان بـ «الإخْلاص» عَشْر مرَّات في كلِّ رَكعة مع طُول فَضْله للدَّيْلمي وغيره: مَوضوع، وفي بعض الرَّسائل، قال عليُّ بن إبراهيم: وممَّا أُحْدِث في لَيلة النِّصف مِن شَعْبان: الصَّلاة الأَلْفيَّة، مائة رَكعة بـ «الإخْلاص» عَشْرًا عَشْرًا بالجماعة، واهْتَمُّوا بها أَكثر مِن الجُمَع والأَعْياد لم يَأْتِ بها خَبَر ولا أَثَر إلَّا ضَعيف أوْ مَوضوع، ولا تَغْترَّ بِذِكر صاحب «القُوت» و«الإِحياء» وغيرهما، وكان للعَوامِّ بهذه الصَّلاة افْتِتان عظيم، حتَّى الْتَزم بسببها كَثْرة الوَقيد، وتَرتَّب عليه مِن الفُسُوق وانْتِهاك المَحارم ما يُغني عن وَصْفه، حتَّى خَشِي الأَولياء مِن الخَسْف، وهَرَبوا فيها إلى البَرَارِي»(16).
كما أُنَبِّه ـ أَيضًا ـ على عَدَم مَشْروعِيَّة تَخْصيص صَوْم يَوم لَيلة النِّصف مِن شَعبان، لِعَدم وُرُود ما يَدلُّ عليه، لذا قال المُباركفوري: «والحاصِل أنَّه ليس في صَوْم يوم لَيلة النِّصف مِن شَعبان حَديث مَرفوع صحيح أو حَسَن أو ضَعيف خَفيف الضُّعف، ولا أَثَر قَوِيٌّ أو ضعيف»(17).
2 ـ قَضاء رَمضان في شَعْبان:
ذَكرتْ أُمُّ المُؤمنين عائشة رضي الله عنهما أنَّ الأَمْر الذي كان يَمْنعها وسائِر نِساء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن تَعْجيل قضاء رَمضان حتَّى يَأتي شَعبان: هو الشُّغْل مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أحاديث أَذْكُر منها ما يلي:
1 ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنهما تَقُولُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم»(18).
2 ـ وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ»(19).
3 ـ وعَنْها ـ أيضًا ـ رضي الله عنهما قَالَتْ: «مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم»(20).
«والمُراد مِن الشُّغْل: أَنَّها كانتْ مُهَيِّئة نَفْسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مُتَرَصِّدة لاسْتِمْتاعه في جميع أَوقاتها إنْ أراد ذلك، وأمَّا في شَعْبان فإنَّه صلى الله عليه وسلم كان يَصُومه، فتَتفرَّغ عائشة لِقضاء صَوْمها... وممَّا يُسْتفاد مِن هذا الحديث: أنَّ القضاء مُوسَّع، ويَصير في شَعْبان مُضيَّقًا، ويُؤْخَذ مِن حِرْصها على القضاء في شَعْبان أنَّه لا يجوز تَأْخير القضاء حتَّى يَدخُل رَمضان، فإنْ دَخل فالقضاء واجبٌ ـ أيضًا ـ فلا يَسْقُط»(21).
وتَجْدُر الإشارة ـ هنا ـ إلى أنَّ بعض العُلماء يرى أنَّ الجُملة الواردة في هذه الرِّواية الأُولى، وهي: «الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» لَيستْ مِن قَول أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهما بل مُدْرَجة في الحديث.
قال الألباني رحمه الله: «واعْلَم أنَّ ابن القَيِّم والحافظ وغيرهما قدْ بَيَّنا أنَّ قوله ـ في الحديث ـ: «الشُّغل مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم» مُدْرَج في الحديث، ليس مِن كلام عائشة، بل مِن كلام أَحَد رُواته، وهو يحيى بن سَعيد، ومِن الدَّليل على ذلك قول يحيى في رواية لمسلم: «فَظَنَنْتُ أنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم». ولكنْ هذا لا يَخْدُج فيما ذَكرنا؛ لأنَّنا لم نَسْتدلَّ عليه بهذا المُدْرَج، بل بِقَوْلها: «فَمَا أَسْتَطِيعُ...»، والمُدْرَج إنَّما هو بيان لِسبب عَدم الاستطاعة، وهذا لا يَهُمُّنا في الموضوع، ولا أَدْري كيف خَفِي هذا على الحافظ حيث قال في ـ خاتمة شَرْح الحديث ـ: «وفي الحديث دَلالة على جَواز تَأْخير قضاء رَمضان مُطلقا سواء كان لعُذْر أو لِغَير عُذْر؛ لأنَّ الزِّيادة كما بَيَّناه مُدْرَجَة...»؟! فخَفِي عليه أنَّ عَدم اسْتِطاعتها هو العُذْر، فتَأَمَّل»(22).
3 ـ شَعْبان أَحبُّ الشُّهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَصومه:
فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَيْسٍ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: «كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ: شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ»(23).
فإنْ قِيل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخُصُّ شَعْبان بكَثْرة الصِّيام فيه، في حين لم يُعرف عنه مِثل ذلك في شَهْر المُحرَّم، مع أنَّه صلى الله عليه وسلم هو القائِل: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ»(24)؟
إنَّ جماعةً مِن أهل العِلم أَجابوا عن ذلك بقولهم: إنَّ أَفْضل الصِّيام ـ بعد شَهْر رَمضان ـ: شَعْبان؛ لِمُحافظته صلى الله عليه وسلم على صَوْمه أو صَوْم أكثره، ولأنَّه يَسْبِق رَمضان، فيكون صِيامه كالسُّنن الرَّواتب في الصَّلوات الَّتي تكون قَبْلها، وعليه يُحْمَل قَولُه صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعدَ رَمَضَانَ شَهرُ اللهِ المُحَرَّمُ»: على التَّطَوُّع المُطْلق(25).
قال النَّووي رحمه الله: «قَولُه صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعدَ رَمَضَانَ شَهرُ اللهِ المُحَرَّمُ»: تَصْريح بأنَّه أَفضل الشُّهور للصَّوْم، وقد سَبق الجواب عن إكثار النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن صَوْم شَعْبان دُون المُحرَّم، وذكرنا فيه جوابين:
أحدهما: لَعلَّه إنَّما عَلِم فَضْله في آخر حَياته.
والثَّاني: لَعلَّه كان يُعْرَض فيه أَعذار مِن سَفَر أو مَرَض أو غيرهما»(26).