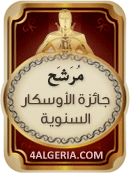السلاام عليكم اعضاء اللمة الجزائرية الكرام :
في حياتنا اليومية نصطدم ببعض الدراسات والمعلومات التي يصرحها بعضنا لبعضنا الآخر وكمثال لتوضيح ذالك
يقول لك احدهم : كشفت دراسة طبيبة ان كذا وكذا
او قال احد الدكاترة كذا وكذا ونجد ان كثيرا من هاته المعلومات تنتشر في عالم النت خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي
لكن الملفت للانتباه ان غالبية المستخدمين او غالبية الناس لا تهتم بمصدر الدرااسة
فيكفي ان تبحث في النت عن تلك الجامعة التي نشرت تلك الدرااسة حتى تكتشف انها غير موجودة اصلا
ويكفي ان تبحث عن ذالك الدكتور حتى تكتشف انه لا وجود له
اذن لماذا لا يمتلك المجتمع ثقافة المصادر احيانا يقتلني الفضول حين اتعامل مع مثل هذا الغبااء
فيكفي من احدنا ان يكتب تقريرا عن فوائد نهيق الحمار العلمية:
وتكتب كشفت دراسة علمية اجرتها جامعة HAMIR USA الامريكية ان نهيق الحمار
مفيد للحكة وهو معالج كبير لالتهابات المعدة ويسرع في الدورة الدموية
حتى تجد موجة من الاغبياء ينشرون تلك المعولمة السخيفة فبالله عليكم
افي نهيق الحمار فائدة وهل هناك جامعة امريكية اسمها جامعة الحمير .
اسئلتي النقاشية :
ماهي مكانة المصادر في ثقافة المجتمع الجزائري؟
وهل يستطيع الجزائري ان يعود للكتاب الذي ذكرت فيه تلك الفتوة او تلك المعلومة ؟
متى نكف عن نشر مثل تك الغباءات بين ابنائنا واهالينا ؟
كتبه : حكيم ستوري
في حياتنا اليومية نصطدم ببعض الدراسات والمعلومات التي يصرحها بعضنا لبعضنا الآخر وكمثال لتوضيح ذالك
يقول لك احدهم : كشفت دراسة طبيبة ان كذا وكذا
او قال احد الدكاترة كذا وكذا ونجد ان كثيرا من هاته المعلومات تنتشر في عالم النت خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي
لكن الملفت للانتباه ان غالبية المستخدمين او غالبية الناس لا تهتم بمصدر الدرااسة
فيكفي ان تبحث في النت عن تلك الجامعة التي نشرت تلك الدرااسة حتى تكتشف انها غير موجودة اصلا
ويكفي ان تبحث عن ذالك الدكتور حتى تكتشف انه لا وجود له
اذن لماذا لا يمتلك المجتمع ثقافة المصادر احيانا يقتلني الفضول حين اتعامل مع مثل هذا الغبااء
فيكفي من احدنا ان يكتب تقريرا عن فوائد نهيق الحمار العلمية:
وتكتب كشفت دراسة علمية اجرتها جامعة HAMIR USA الامريكية ان نهيق الحمار
مفيد للحكة وهو معالج كبير لالتهابات المعدة ويسرع في الدورة الدموية
حتى تجد موجة من الاغبياء ينشرون تلك المعولمة السخيفة فبالله عليكم
افي نهيق الحمار فائدة وهل هناك جامعة امريكية اسمها جامعة الحمير .
اسئلتي النقاشية :
ماهي مكانة المصادر في ثقافة المجتمع الجزائري؟
وهل يستطيع الجزائري ان يعود للكتاب الذي ذكرت فيه تلك الفتوة او تلك المعلومة ؟
متى نكف عن نشر مثل تك الغباءات بين ابنائنا واهالينا ؟
كتبه : حكيم ستوري