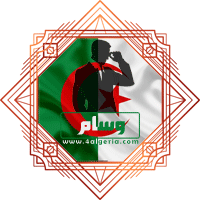حديث: يا غلام إني أعلمك كلمات
ضمن شرح أحاديث الأربعين النووية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
وعن أبي العباس عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال (كنت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف ) رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي (احفظ الله تجده أمامك، تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا ).
هذا حديث عظيم جدا من وصايا المصطفى -عليه الصلاة والسلام- خص بها ابن عمه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وهذه الوصية جمعت خيري الدنيا والآخرة؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى عبد الله بن عباس، وأمره بقوله (يا غلام إني أعلمك كلمات) وهذا اللفظ فيه تودد المعلم والأب والكبير إلى الصغار، وإلى من يريد أن يوجه بالألفاظ الحسنة، فهو استعمل -عليه الصلاة والسلام- لفظ التعليم: (إني أعلمك كلمات) وهي أوامر، فلم يقل له -عليه الصلاة والسلام-: إني آمرك بكذا وكذا، وإنما ذكر لفظ التعليم؛ لأنه من المعلوم أن العاقل يحب أن يستفيد علما.
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: (يا غلام إني أعلمك كلمات) والكلمات: جمع كلمة والمقصود بها هنا: الجمل؛ لأن الكلمة في الكتاب والسنة غير الكلمة عند النحاة، الكلمة عند النحاة: اسم أو فعل أو حرف، أما في الكتاب والسنة فالكلمة: هي الجملة، كما قال -جل وعلا-: (كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا) يريد بها ما جاء في الآية قبلها: (رَبِّ ارْجِعُونِ).
وثبت -أيضا- في مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: (أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد:
ألا كل شيء ما خلا الله باطلُ)
قال: (أصدق كلمة) فإذن الكلمة يُعنى بها: الجمل، فقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إني أعلمك كلمات) يعني: إني أعلمك جملا ووصايا، فأرعها سمعك.
قال -عليه الصلاة والسلام- بعدها: (احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك).
هذه هي الوصية الأولى: (احفظ الله يحفظك) فهنا أمره بأن يحفظ الله، ورتب عليه أن الله -جل وعلا- يحفظه، وحفظ العبد ربه -جل وعلا- المراد منه: أن يحفظه في حقوقه -جل وعلا-.
وحقوق الله -جل جلاله- نوعان:
حقوق واجبة، وحقوق مستحبة، فحفظ العبد ربه يعني: أن يمتثل (احفظ الله) أن يأتي بالحقوق الواجبة، والحقوق المستحبة، ونعبر بالحقوق تجوزا بالمقابلة، يعني: الحقوق الواجبة والمستحبة، فمن أتى بالواجبات والمستحبات فقد حفظ الله -جل وعلا-؛ لأنه يكون من السابقين بالخيرات، والمقتصد -أيضا- قد حفظ الله -جل وعلا- إذ امتثل الأمر الواجب، وانتهى عن المُحَرَّم.
فأدنى درجات حفظ الله -جل وعلا- أن يحفظ الله -سبحانه وتعالى- بعد إتيانه بالتوحيد بامتثال الأمر، واجتناب النهي، والدرجة التي بعدها المستحبات، هذه يتنوع فيها الناس، وتتفاوت درجاتهم.
قال: (احفظ الله يحفظك).
وحفظ الله -جل وعلا- للعبد على درجتين -أيضا-:
أما الأولى: فهو أن يحفظه في دنياه، أن يحفظ له مصالحه في بدنه بأن يصحه، وفي رزقه بأن يعطيه حاجته، أو أن يوسع عليه في رزقه، وفي أهله بأن يحفظ له أهله وولده، وأنواع الحفظ لمصالح العبد في الدنيا، فكل ما للعبد فيه مصلحة في الدنيا فإنه موعود بأن تحفظ له إذا حفظ الله -جل وعلا- بأداء حقوق الله -جل جلاله- والاجتناب عن المحرمات.
والدرجة الثانية من حفظ الله -جل وعلا- للعبد، وهي أعظم الدرجتين وأرفعهما وأبلغهما عند أهل الإيمان، وفي قلوب أهل العرفان، هي: أن يحفظ الله -جل وعلا- العبد في دينه، بأن يسلم له دينه بإخلاء القلب من تأثير الشبهات فيه، وإخلاء الجوارح من تأثير الشهوات فيها، وأن يكون القلب معلقا بالرب -جل وعلا-، وأن يكون أُنسه بالله، ورغبه في الله، وإنابته إليه، وخلوته المحبوبة بالله -جل جلاله-.
كما جاء في حديث "الولي" المعروف، الذي رواه البخاري في الصحيح وغيره -أيضا- قال -عليه الصلاة والسلام-: قال الله -تعالى- في جمل ابتدأ بها الحديث، ثم قال: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له من ذلك).
فحفظ الله -جل وعلا- العبد في الدين هذا أعظم المطالب، ولهذا كان -عليه الصلاة والسلام- يدعو الله كثيرا أن يُحفَظَ من الفتن وأن يحفظه الله -جل وعلا- من تقليب القلب، (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك) ونحو ذلك.
وكان كثيرا ما يقسم (لا ومقلب القلوب) فالعبد أعظم المطالب التي يحرص عليها أن يسلم له دينه، والله -جل وعلا- قد يبتلي العبد بخلل في دينه، وشبهات تطرأ عليه لتفريطه في بعض ما يجب أن يُحفظ اللهُ -جل وعلا- فيه؛ فلهذا العبد إذا حصل له إخلال في الدين، فإنه قد أخل بحفظ الله -جل وعلا-، وقد يعاقب بأن يُجعل غافلا، وقد يُعاقب بحرمانه البصيرة في العلم، وقد يُعاقب بأن تأتيه الشبهة ولا يحسن كيف يتعامل معها، ولا كيف يردها.
وقد يُعاقب بأنه تأتيه الشبهة فتتمكن منه، كما قال -جل وعلا-: (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) وكما قال: (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ) وكما قال -جل وعلا- (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ) وكما قال -جل وعلا- (إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا ) الآية في الأعراف.
وهكذا في آيات أخر دلت على أن العبد قد يخذل، وخذلانه في أمر الدين هو أعظم الخذلان، ولهذا ينبغي للعبد أن يحرص تمام الحرص على أن يحفظ الله -جل وعلا- في أمره سبحانه، وإن فاته الامتثال فلا يفته الاستغفار، والإنابة واعتقاد الحق، وعدم التردد والسرعة باتباع السيئة بالحسنة لعلها أن تُمحى.
لهذا فإن حفظ الله -جل وعلا- للعبد بأن يكون الحفظ في الدين أعظم من أن يحفظ في أمر دنياه، ولهذا في قول الله -جل وعلا- في سورة المائدة (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (قال -جل وعلا-: (وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة) قوله: (وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ) يعني: تركوا نصيبا مما أُمروا به، تركوه عن عمد وعن علم، فلما علموه تركوه عن بصيرة فعوقبوا بالفرقة، (فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ).
وهذا من أنواع العقوبات التي يبتلي الله -جل وعلا- بها العباد، ويعاقب بها المؤمنين؛ حيث يعاقبهم بالفرقة؛ لأنهم تركوا ما أوجب الله -جل وعلا- عليهم من مقتضى العلم، وهذا نوع من أنواع ترك حفظ الله -جل وعلا- للعبد، فالعبد بحاجة أن يحفظه الله -سبحانه وتعالى- بتوفيقه له، ومعيته له، وتسديده إياه.
حفظ الله -جل وعلا- للعبد في الدين، أو في الدنيا -أيضا- راجع إلى معية الله -سبحانه وتعالى- والمراد بها: المعية الخاصة التي مقتضاها: التوفيق والإلهام والتسديد والنصر والإعانة.
قال: (احفظ الله تجده تجاهك) يعني: احفظ الله على نحو ما وصفنا تجده دائما على ما طلبت، تجده دائما قريبا منك، يعطيك ما سألت، كما ذكرت لك في حديث "الولي" (ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه).
قال -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلك، (إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله) هذا مأخوذ من قول الله -جل وعلا- (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وفيه إفراد الله -جل وعلا- بالاستعانة وبالسؤال، وهذه على مرتبتين:-
الأولى: واجبة، وهي التوحيد بأن يستعين بالله -جل جلاله- وحده دون ما سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله -جل وعلا-، فهذا واجب أن يُفرد الله -جل وعلا- بالاستعانة، وكذلك أن يسأل الله -جل وعلا- وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله -جل وعلا-، هذا هو المعروف عندكم في التوحيد فيما يكون من الدعاء صرفه لغير الله -جل وعلا- شرك، وكذلك في الاستعانة التي يكون صرفها لغير الله -جل وعلا- شركا.
المرتبة الثانية: المستحبة، وهو أنه إذا أمكنه أن يقوم بالعمل، فإنه لا يسأل أحدا من الناس شيئا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخذ العهد على عدد من الصحابة ألا يسألوا الناس شيئا، قال الراوي: (فكان أحدهم يسقط سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه) وهذا من المراتب التي يتفاوت فيها الناس.
فإذا أمكنك أن تقوم بالشيء بنفسك فالأفضل والمستحب ألا تسأل أحدا من الخلق في ذلك، إذا أمكنك يعني: بلا كلفة، ولا مشقة، ومن كانت عادته دائما أن يطلب الأشياء فهذا مكروه، وينبغي للعبد أن يوطن نفسه، وأن يعمل بنفسه ما يحتاجه كثيرا، وإذا سأل في أثناء ذلك، فإنه لا يقدح حتى في الدرجة المستحبة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- ربما أَمَر من يأتيه بالشيء، وربما طلب من يفعل له الشيء، وهذا على بعض الأحوال.
َ
قال: (إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله) ظاهر في الوجوب (إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله) على القيد الذي ذكرنا لكم؛ من أن هذا يتناول المرتبة الأولى على الوجوب، والمرتبة الثانية على الاستحباب.
قال -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلك: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف).
هذا فيه بيان القدر الثابت، وأن العباد لن يغيروا من قدر الله -جل وعلا- الماضي شيئا، وأما مَن عظم توكله بالله -جل وعلا-، فإنه لن يضره الخلق، ولو اجتمعوا عليه، كما قال -جل وعلا- لنبيه -عليه الصلاة والسلام-: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ).
وجاء في عدد من الأحاديث بيان هذا الفضل، في أن العبد إذا أحسن توكله على الله -جل وعلا-، وطاعته لله، فإن الله يجعل له مخرجا، ولو كاده من في السماوات، ومن في الأرض لجعل الله -جل وعلا- له من بينهن مخرجا.
والتوكل على الله -جل وعلا- ظاهر من هذه الوصية؛ حيث قال: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك) ثم قال: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك. .. )إلى آخر الجملتين، وهذا فيه إعظام التوكل على الله -جل وعلا-.
والتوكل على الله -سبحانه وتعالى- من أعظم المقامات؛ مقامات الإيمان، بل هو مقام الأنبياء والمرسلين في تحقيق عبوديتهم العظيمة للرب -جل وعلا-.
والتوكل على الله معناه: أن يفعل السبب الذي أُمر به، ثم يفوض أمره إلى الله -جل وعلا- في الانتفاع بالأسباب، وإذا كان ما لديه من الأمر لا يملك أن يفعل له سببا فإنه يفوض أمره إلى الله -جل وعلا- كما قال سبحانه في ذكر مؤمن آل فرعون: (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) وهذا التفويض إلى الله -جل وعلا- عمل القلب خاصة، يعني: أن يلتجئ بقلبه، وأن يعتمد بقلبه على الله -جل وعلا- في تحصيل مراده، أو دفع الشر الذي يخشاه، والعباد إذا تعامل معهم فإنما يتعامل معهم على أنهم أسباب، والسبب قد ينفع، وقد لا ينفع، فإذا تعلق القلب بالخلق أوتي من هذه الجهة، ولم يكن كاملا في توكله.
فتعلق القلب بالخلق مذموم، والذي ينبغي: أن يتوكل على الله، وأن يعلق قلبه بالله -جل وعلا-، وألا يتعلق بالخلق، حتى ولو كانوا أسبابا، فينظر إليهم على أنهم أسباب، والنافع والذي يجعل السبب سببا، وينفع به هو الله -جل وعلا-.
إذا قام هذا في القلب فإن العبد يكون مع ربه -جل وعلا-، ويعلم أنه لن يكون له إلا ما قدره الله -جل وعلا- له، ولن يمضي عليه إلا ما كتبه الله -جل وعلا- عليه.
قال -عليه الصلاة والسلام- (رفعت الأقلام، وجفت الصحف) يعني: أن الأمر مضى وانتهى، وهذا لا يدل، كما ذكرته لكم فيما سبق، لا يدل على أن الأمر على الإجبار، بل إن القدر ماض، والعبد يمضي فيما قدره الله -جل وعلا-؛ لأجل التوكل عليه، وحسن الظن به، وتفويض الأمر إليه، وهو إخلاء القلب من رؤية الخلق.
قال: وفي رواية غير الترمذي: (احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك).
قوله: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ) تعرُّف العبد إلى ربه هو: علمه بما يستحقه -جل وعلا-، (تعرف إلى الله في الرخاء) يعني: تعلم ما يستحقه -جل وعلا- عليك، ما يستحقه -جل وعلا- منك؛ توحيده في ربوبيته، وإلهيته، وفي أسمائه وصفاته، ما يستحقه -جل وعلا- من طاعته في أوامره، وطاعته فيما نهى عنه باجتناب المنهيات، وما يستحقه -جل وعلا- من إقبال القلب عليه، وإنابة القلب إليه، والتوكل عليه، والرغب فيما عنده، وإخلاء القلب من الأغيار، يعني: من غيره -جل وعلا-، واتباع ما يحب ويرضى من أعمال القلوب.
(تعرف إلى الله في الرخاء) يعني: إذا كنت في رخاء من أمرك، بحيث قد يأتي لبعض النفوس أنها غير محتاجة لأحد، هنا (تعرف إلى الله في الرخاء) واطلب ما عنده، وتعلم ما يستحقه -جل وعلا-، واَتبع ذلك بالامتثال، فإن هذا من أفضل الأعمال الصالحة، بل هو لب الدين وعماده، العلم بما يستحقه -جل وعلا-، ثم العمل بذلك، إذا حصل منك التعرف إلى الله، والتعرف على الله -جل وعلا- عرفك الله في الشدة، قال: (يعرفك في الشدة) وكلمة: "يعرفك" هذه جاءت على جهة الفعل، ومعلوم في باب الصفات أن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات.
فهذا إذن لا يقتضي أن يكون من صفاته -جل وعلا- المعرفة، فإنه لا يوصف الله -جل وعلا- بأنه ذو معرفة، بل يقيد هذا على جهة المقابلة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- هنا: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ) فيجوز أن تستعمل لفظ "يعرف" على الفعلية، وفي مقابلةِ لفظِ يعرف آخر، كما في نظائره كقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إن الله لا يمل حتى تملوا) وكما في قول الله -جل وعلا-: (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ) وفي قوله: (مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ) (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ) وأشباه ذلك من الألفاظ التي جاءت بصيغة الفعل، ومجيئها بلفظ الفعل لا يدل على إطلاقها صفة؛ لأنها جاءت على لفظ المقابلة.
ومجيء بعض الصفات، يعني: على جهة الأفعال بالمقابلة هذا يدل على الكمال، ومعلوم أن المعرفة غير العلم، العلم كمال، وأما المعرفة فإنها قد تشوبها شائبة النقص؛ لأن لفظ المعرفة، وصفة المعرفة هذه قد يسبقها جهل، يعني: عرف الشيء يعني: تعرف إليه بصفاته، وهذا يقتضي أنه كان -ربما- جاهلا به غير عالم به.
أما العلم فهو صفة لا تقتضي، ولا يلزم منها سبق عدم علم، أو سبق جهل، وأشباه ذلك، ولهذا كان من أسماء الله الحسنى: "العليم" ولم يكن من أسمائه -جل وعلا- العارف، وأشباه ذلك.
إذا تقرر هذا فلفظ المعرفة جاء في القرآن على جهة الذم قال -جل وعلا-: (يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا (وقال -جل وعلا-: (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (والآية الأخرى -أيضا- في الأنعام، والآية الأخرى -أيضا- في البقرة في هذا.
فلفظ المعرفة جاء على جهة الذم في غالب ما جاء في الكتاب والسنة، وقد يكون يأتي على معنى العلم، كما في هذا الحديث.
فإذن قوله: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) من جهة الصفات هذا بحثه ما معناه معرفة الله للعبد في الشدة، قال العلماء: هذه معناها المعية، ومعرفة الله -جل وعلا- للعبد في الشدة يعني: أن يكون معه بمعية النصر والتأييد والتوفيق وأشباه ذلك.
قال: (واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك) وهذا في القدر ومن قرأ بحثه، قال: (واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا) هذا فيه الأمر بالصبر، وأن مع الكرب يأتي الفرج، وأن مع العسر يأتي اليسر، كما قال -جل وعلا-: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا).
وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لن يغلب عسر يسرين) وهذا من فضل الله -جل وعلا- قد قال الشاعر:
اشـتدي أزمة تنفرجي ... قد آذن ليلك بالبلج
في القصيدة المسماة بـ"المنفرجة" وهذا يدل على أن العبد إذا اشتد عليه الأمر، وأحسن الصبر، وأحسن الظن بالله -جل وعلا- فإنه يؤذن له بأن ينفرج كربه، وأن ييسر له عسره، والصبر أمر به هنا في قوله: (واعلم أن النصر مع الصبر) والنصر مطلوب، فصار الصبر مطلوبا، والصبر مرتبة واجبة، وإذا حصل كرب ومصيبة، كما قال: (ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك) إذا حصلت مصيبة فإن الصبر واجب يعني: الصبر أمر الله به، وهو واجب على كل أحد، ومعنى الصبر الواجب: أن يحبس اللسان عن الشكوى، ويحبس القلب عن التسخط، ويحبس الجوارح عن التصرف بما لا يجوز من شق أو نياحة أو لطم، وأشباه ذلك من الأفعال في غير مصيبة الموت.
فإذن الصبر فيه حبس اللسان عن التشكي، كما هو تعريف الصبر، قيل للإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: هذا رجل ظلمه السلطان فأخذ يدعو عليه، قال أحمد: هذا خلاف الصبر الذي أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- مع السلطان، لا يدعى عليه.
وهذا له مأخذ آخر من جهة أن الكرب الذي ربما أتى من السلطان إذا تشكى المؤمن منه فإنه يخالف حبس اللسان عن التشكي، ولهذا لما جاء أحد الصحابة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكر له ما يلقى من المشركين من الشدة غضب النبي -عليه الصلاة والسلام- لأجل أنهم لم يصبروا، وقال: (إنه كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين ما بين جلده وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، فوالله ليتمن الله هذا الأمر. .. )الحديث، فدل هذا على أن الصبر واجب في جميع الحالات.
والصبر حبس للسان عن التشكي، وحبس للقلب عن التسخط، وحبس للجوارح عن التصرف في غير ما يرضي الله -جل وعلا-؛ ولهذا أمر الله نبيه أن يصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل، (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) وكل مخالفة لهذا الواجب يأتي لها أضدادها في حياة العبد، إما الخاصة أو العامة.
المرتبة الثانية المستحبة هي: الرضا.
الرضا بما قدر الله -جل وعلا-، فالصبر واجب، وأما الرضا فمستحب، الرضا بالمصيبة مستحب، ومعنى الرضا بالمصيبة: أن يستأنس لها، ويعلم أنها خير له، فيقول: هي خير لي، ويرضى بها في داخله، ويسلم لها، ولا يجد في قلبه تسخطا عليها، أو لا يجد في قلبه رغبة في أن لا تكون جاءته، بل يقول: الخير في هذه، وهذه مرتبة خاصة.
وهناك فرق ما بين الرضا الواجب، والرضا المستحب في المصيبة، فإن المصيبة إذا وقعت تعلق بها نوعان من الرضا: رضا واجب ورضا مستحب، والرضا الواجب هو: الرضا بفعل الله -جل وعلا-، والرضا المستحب هو: الرضا بالمصيبة، يعني: الرضا بفعل الله هذا واجب؛ لأنه لا يجوز للعبد ألا يرضى بتصرف الله -جل وعلا- في ملكوته، بل يرضى بما فعل الله -جل وعلا- في ملكوته، ولا يكون في نفسه معارضة لله -جل وعلا- في تصرفه في ملكوته، هذا القدر واجب.
وأما المستحب فهو الرضا بالمصيبة يعني: الرضا بالمقضي، فهناك فرق ما بين الرضا بالقضاء، والرضا بالمقضي، فالرضا بالقضاء الذي هو فعل الله -جل وعلا- هذا واجب، والرضا بالمقضي هذا مستحب، ونقف عند هذا، وأنبه إلى أني لن أتمكن من الحضور للدرس من يوم غد إلى ليلة الأحد، وألتقي بكم -إن شاء الله- ليلة الاثنين بإذنه تعالى، وذلك لطارئ طرأ، وسنكمل -إن شاء الله- هذا الشرح، ولو أخذنا وقتا بعد الفجر أو بعد العصر -إن شاء الله- نعدكم بإكماله، إكمال شرح هذه الأربعين.
أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد
أما بعد فهذه صله لما تقدم من شرح الأحاديث الأربعين النووية، وقد وقفنا عند الحديث العشرين.
ضمن شرح أحاديث الأربعين النووية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
وعن أبي العباس عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال (كنت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف ) رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي (احفظ الله تجده أمامك، تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا ).
هذا حديث عظيم جدا من وصايا المصطفى -عليه الصلاة والسلام- خص بها ابن عمه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وهذه الوصية جمعت خيري الدنيا والآخرة؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى عبد الله بن عباس، وأمره بقوله (يا غلام إني أعلمك كلمات) وهذا اللفظ فيه تودد المعلم والأب والكبير إلى الصغار، وإلى من يريد أن يوجه بالألفاظ الحسنة، فهو استعمل -عليه الصلاة والسلام- لفظ التعليم: (إني أعلمك كلمات) وهي أوامر، فلم يقل له -عليه الصلاة والسلام-: إني آمرك بكذا وكذا، وإنما ذكر لفظ التعليم؛ لأنه من المعلوم أن العاقل يحب أن يستفيد علما.
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: (يا غلام إني أعلمك كلمات) والكلمات: جمع كلمة والمقصود بها هنا: الجمل؛ لأن الكلمة في الكتاب والسنة غير الكلمة عند النحاة، الكلمة عند النحاة: اسم أو فعل أو حرف، أما في الكتاب والسنة فالكلمة: هي الجملة، كما قال -جل وعلا-: (كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا) يريد بها ما جاء في الآية قبلها: (رَبِّ ارْجِعُونِ).
وثبت -أيضا- في مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: (أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد:
ألا كل شيء ما خلا الله باطلُ)
قال: (أصدق كلمة) فإذن الكلمة يُعنى بها: الجمل، فقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إني أعلمك كلمات) يعني: إني أعلمك جملا ووصايا، فأرعها سمعك.
قال -عليه الصلاة والسلام- بعدها: (احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك).
هذه هي الوصية الأولى: (احفظ الله يحفظك) فهنا أمره بأن يحفظ الله، ورتب عليه أن الله -جل وعلا- يحفظه، وحفظ العبد ربه -جل وعلا- المراد منه: أن يحفظه في حقوقه -جل وعلا-.
وحقوق الله -جل جلاله- نوعان:
حقوق واجبة، وحقوق مستحبة، فحفظ العبد ربه يعني: أن يمتثل (احفظ الله) أن يأتي بالحقوق الواجبة، والحقوق المستحبة، ونعبر بالحقوق تجوزا بالمقابلة، يعني: الحقوق الواجبة والمستحبة، فمن أتى بالواجبات والمستحبات فقد حفظ الله -جل وعلا-؛ لأنه يكون من السابقين بالخيرات، والمقتصد -أيضا- قد حفظ الله -جل وعلا- إذ امتثل الأمر الواجب، وانتهى عن المُحَرَّم.
فأدنى درجات حفظ الله -جل وعلا- أن يحفظ الله -سبحانه وتعالى- بعد إتيانه بالتوحيد بامتثال الأمر، واجتناب النهي، والدرجة التي بعدها المستحبات، هذه يتنوع فيها الناس، وتتفاوت درجاتهم.
قال: (احفظ الله يحفظك).
وحفظ الله -جل وعلا- للعبد على درجتين -أيضا-:
أما الأولى: فهو أن يحفظه في دنياه، أن يحفظ له مصالحه في بدنه بأن يصحه، وفي رزقه بأن يعطيه حاجته، أو أن يوسع عليه في رزقه، وفي أهله بأن يحفظ له أهله وولده، وأنواع الحفظ لمصالح العبد في الدنيا، فكل ما للعبد فيه مصلحة في الدنيا فإنه موعود بأن تحفظ له إذا حفظ الله -جل وعلا- بأداء حقوق الله -جل جلاله- والاجتناب عن المحرمات.
والدرجة الثانية من حفظ الله -جل وعلا- للعبد، وهي أعظم الدرجتين وأرفعهما وأبلغهما عند أهل الإيمان، وفي قلوب أهل العرفان، هي: أن يحفظ الله -جل وعلا- العبد في دينه، بأن يسلم له دينه بإخلاء القلب من تأثير الشبهات فيه، وإخلاء الجوارح من تأثير الشهوات فيها، وأن يكون القلب معلقا بالرب -جل وعلا-، وأن يكون أُنسه بالله، ورغبه في الله، وإنابته إليه، وخلوته المحبوبة بالله -جل جلاله-.
كما جاء في حديث "الولي" المعروف، الذي رواه البخاري في الصحيح وغيره -أيضا- قال -عليه الصلاة والسلام-: قال الله -تعالى- في جمل ابتدأ بها الحديث، ثم قال: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له من ذلك).
فحفظ الله -جل وعلا- العبد في الدين هذا أعظم المطالب، ولهذا كان -عليه الصلاة والسلام- يدعو الله كثيرا أن يُحفَظَ من الفتن وأن يحفظه الله -جل وعلا- من تقليب القلب، (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك) ونحو ذلك.
وكان كثيرا ما يقسم (لا ومقلب القلوب) فالعبد أعظم المطالب التي يحرص عليها أن يسلم له دينه، والله -جل وعلا- قد يبتلي العبد بخلل في دينه، وشبهات تطرأ عليه لتفريطه في بعض ما يجب أن يُحفظ اللهُ -جل وعلا- فيه؛ فلهذا العبد إذا حصل له إخلال في الدين، فإنه قد أخل بحفظ الله -جل وعلا-، وقد يعاقب بأن يُجعل غافلا، وقد يُعاقب بحرمانه البصيرة في العلم، وقد يُعاقب بأن تأتيه الشبهة ولا يحسن كيف يتعامل معها، ولا كيف يردها.
وقد يُعاقب بأنه تأتيه الشبهة فتتمكن منه، كما قال -جل وعلا-: (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) وكما قال: (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ) وكما قال -جل وعلا- (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ) وكما قال -جل وعلا- (إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا ) الآية في الأعراف.
وهكذا في آيات أخر دلت على أن العبد قد يخذل، وخذلانه في أمر الدين هو أعظم الخذلان، ولهذا ينبغي للعبد أن يحرص تمام الحرص على أن يحفظ الله -جل وعلا- في أمره سبحانه، وإن فاته الامتثال فلا يفته الاستغفار، والإنابة واعتقاد الحق، وعدم التردد والسرعة باتباع السيئة بالحسنة لعلها أن تُمحى.
لهذا فإن حفظ الله -جل وعلا- للعبد بأن يكون الحفظ في الدين أعظم من أن يحفظ في أمر دنياه، ولهذا في قول الله -جل وعلا- في سورة المائدة (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (قال -جل وعلا-: (وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة) قوله: (وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ) يعني: تركوا نصيبا مما أُمروا به، تركوه عن عمد وعن علم، فلما علموه تركوه عن بصيرة فعوقبوا بالفرقة، (فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ).
وهذا من أنواع العقوبات التي يبتلي الله -جل وعلا- بها العباد، ويعاقب بها المؤمنين؛ حيث يعاقبهم بالفرقة؛ لأنهم تركوا ما أوجب الله -جل وعلا- عليهم من مقتضى العلم، وهذا نوع من أنواع ترك حفظ الله -جل وعلا- للعبد، فالعبد بحاجة أن يحفظه الله -سبحانه وتعالى- بتوفيقه له، ومعيته له، وتسديده إياه.
حفظ الله -جل وعلا- للعبد في الدين، أو في الدنيا -أيضا- راجع إلى معية الله -سبحانه وتعالى- والمراد بها: المعية الخاصة التي مقتضاها: التوفيق والإلهام والتسديد والنصر والإعانة.
قال: (احفظ الله تجده تجاهك) يعني: احفظ الله على نحو ما وصفنا تجده دائما على ما طلبت، تجده دائما قريبا منك، يعطيك ما سألت، كما ذكرت لك في حديث "الولي" (ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه).
قال -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلك، (إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله) هذا مأخوذ من قول الله -جل وعلا- (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وفيه إفراد الله -جل وعلا- بالاستعانة وبالسؤال، وهذه على مرتبتين:-
الأولى: واجبة، وهي التوحيد بأن يستعين بالله -جل جلاله- وحده دون ما سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله -جل وعلا-، فهذا واجب أن يُفرد الله -جل وعلا- بالاستعانة، وكذلك أن يسأل الله -جل وعلا- وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله -جل وعلا-، هذا هو المعروف عندكم في التوحيد فيما يكون من الدعاء صرفه لغير الله -جل وعلا- شرك، وكذلك في الاستعانة التي يكون صرفها لغير الله -جل وعلا- شركا.
المرتبة الثانية: المستحبة، وهو أنه إذا أمكنه أن يقوم بالعمل، فإنه لا يسأل أحدا من الناس شيئا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخذ العهد على عدد من الصحابة ألا يسألوا الناس شيئا، قال الراوي: (فكان أحدهم يسقط سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه) وهذا من المراتب التي يتفاوت فيها الناس.
فإذا أمكنك أن تقوم بالشيء بنفسك فالأفضل والمستحب ألا تسأل أحدا من الخلق في ذلك، إذا أمكنك يعني: بلا كلفة، ولا مشقة، ومن كانت عادته دائما أن يطلب الأشياء فهذا مكروه، وينبغي للعبد أن يوطن نفسه، وأن يعمل بنفسه ما يحتاجه كثيرا، وإذا سأل في أثناء ذلك، فإنه لا يقدح حتى في الدرجة المستحبة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- ربما أَمَر من يأتيه بالشيء، وربما طلب من يفعل له الشيء، وهذا على بعض الأحوال.
َ
قال: (إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله) ظاهر في الوجوب (إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله) على القيد الذي ذكرنا لكم؛ من أن هذا يتناول المرتبة الأولى على الوجوب، والمرتبة الثانية على الاستحباب.
قال -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلك: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف).
هذا فيه بيان القدر الثابت، وأن العباد لن يغيروا من قدر الله -جل وعلا- الماضي شيئا، وأما مَن عظم توكله بالله -جل وعلا-، فإنه لن يضره الخلق، ولو اجتمعوا عليه، كما قال -جل وعلا- لنبيه -عليه الصلاة والسلام-: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ).
وجاء في عدد من الأحاديث بيان هذا الفضل، في أن العبد إذا أحسن توكله على الله -جل وعلا-، وطاعته لله، فإن الله يجعل له مخرجا، ولو كاده من في السماوات، ومن في الأرض لجعل الله -جل وعلا- له من بينهن مخرجا.
والتوكل على الله -جل وعلا- ظاهر من هذه الوصية؛ حيث قال: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك) ثم قال: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك. .. )إلى آخر الجملتين، وهذا فيه إعظام التوكل على الله -جل وعلا-.
والتوكل على الله -سبحانه وتعالى- من أعظم المقامات؛ مقامات الإيمان، بل هو مقام الأنبياء والمرسلين في تحقيق عبوديتهم العظيمة للرب -جل وعلا-.
والتوكل على الله معناه: أن يفعل السبب الذي أُمر به، ثم يفوض أمره إلى الله -جل وعلا- في الانتفاع بالأسباب، وإذا كان ما لديه من الأمر لا يملك أن يفعل له سببا فإنه يفوض أمره إلى الله -جل وعلا- كما قال سبحانه في ذكر مؤمن آل فرعون: (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) وهذا التفويض إلى الله -جل وعلا- عمل القلب خاصة، يعني: أن يلتجئ بقلبه، وأن يعتمد بقلبه على الله -جل وعلا- في تحصيل مراده، أو دفع الشر الذي يخشاه، والعباد إذا تعامل معهم فإنما يتعامل معهم على أنهم أسباب، والسبب قد ينفع، وقد لا ينفع، فإذا تعلق القلب بالخلق أوتي من هذه الجهة، ولم يكن كاملا في توكله.
فتعلق القلب بالخلق مذموم، والذي ينبغي: أن يتوكل على الله، وأن يعلق قلبه بالله -جل وعلا-، وألا يتعلق بالخلق، حتى ولو كانوا أسبابا، فينظر إليهم على أنهم أسباب، والنافع والذي يجعل السبب سببا، وينفع به هو الله -جل وعلا-.
إذا قام هذا في القلب فإن العبد يكون مع ربه -جل وعلا-، ويعلم أنه لن يكون له إلا ما قدره الله -جل وعلا- له، ولن يمضي عليه إلا ما كتبه الله -جل وعلا- عليه.
قال -عليه الصلاة والسلام- (رفعت الأقلام، وجفت الصحف) يعني: أن الأمر مضى وانتهى، وهذا لا يدل، كما ذكرته لكم فيما سبق، لا يدل على أن الأمر على الإجبار، بل إن القدر ماض، والعبد يمضي فيما قدره الله -جل وعلا-؛ لأجل التوكل عليه، وحسن الظن به، وتفويض الأمر إليه، وهو إخلاء القلب من رؤية الخلق.
قال: وفي رواية غير الترمذي: (احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك).
قوله: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ) تعرُّف العبد إلى ربه هو: علمه بما يستحقه -جل وعلا-، (تعرف إلى الله في الرخاء) يعني: تعلم ما يستحقه -جل وعلا- عليك، ما يستحقه -جل وعلا- منك؛ توحيده في ربوبيته، وإلهيته، وفي أسمائه وصفاته، ما يستحقه -جل وعلا- من طاعته في أوامره، وطاعته فيما نهى عنه باجتناب المنهيات، وما يستحقه -جل وعلا- من إقبال القلب عليه، وإنابة القلب إليه، والتوكل عليه، والرغب فيما عنده، وإخلاء القلب من الأغيار، يعني: من غيره -جل وعلا-، واتباع ما يحب ويرضى من أعمال القلوب.
(تعرف إلى الله في الرخاء) يعني: إذا كنت في رخاء من أمرك، بحيث قد يأتي لبعض النفوس أنها غير محتاجة لأحد، هنا (تعرف إلى الله في الرخاء) واطلب ما عنده، وتعلم ما يستحقه -جل وعلا-، واَتبع ذلك بالامتثال، فإن هذا من أفضل الأعمال الصالحة، بل هو لب الدين وعماده، العلم بما يستحقه -جل وعلا-، ثم العمل بذلك، إذا حصل منك التعرف إلى الله، والتعرف على الله -جل وعلا- عرفك الله في الشدة، قال: (يعرفك في الشدة) وكلمة: "يعرفك" هذه جاءت على جهة الفعل، ومعلوم في باب الصفات أن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات.
فهذا إذن لا يقتضي أن يكون من صفاته -جل وعلا- المعرفة، فإنه لا يوصف الله -جل وعلا- بأنه ذو معرفة، بل يقيد هذا على جهة المقابلة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- هنا: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ) فيجوز أن تستعمل لفظ "يعرف" على الفعلية، وفي مقابلةِ لفظِ يعرف آخر، كما في نظائره كقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إن الله لا يمل حتى تملوا) وكما في قول الله -جل وعلا-: (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ) وفي قوله: (مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ) (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ) وأشباه ذلك من الألفاظ التي جاءت بصيغة الفعل، ومجيئها بلفظ الفعل لا يدل على إطلاقها صفة؛ لأنها جاءت على لفظ المقابلة.
ومجيء بعض الصفات، يعني: على جهة الأفعال بالمقابلة هذا يدل على الكمال، ومعلوم أن المعرفة غير العلم، العلم كمال، وأما المعرفة فإنها قد تشوبها شائبة النقص؛ لأن لفظ المعرفة، وصفة المعرفة هذه قد يسبقها جهل، يعني: عرف الشيء يعني: تعرف إليه بصفاته، وهذا يقتضي أنه كان -ربما- جاهلا به غير عالم به.
أما العلم فهو صفة لا تقتضي، ولا يلزم منها سبق عدم علم، أو سبق جهل، وأشباه ذلك، ولهذا كان من أسماء الله الحسنى: "العليم" ولم يكن من أسمائه -جل وعلا- العارف، وأشباه ذلك.
إذا تقرر هذا فلفظ المعرفة جاء في القرآن على جهة الذم قال -جل وعلا-: (يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا (وقال -جل وعلا-: (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (والآية الأخرى -أيضا- في الأنعام، والآية الأخرى -أيضا- في البقرة في هذا.
فلفظ المعرفة جاء على جهة الذم في غالب ما جاء في الكتاب والسنة، وقد يكون يأتي على معنى العلم، كما في هذا الحديث.
فإذن قوله: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) من جهة الصفات هذا بحثه ما معناه معرفة الله للعبد في الشدة، قال العلماء: هذه معناها المعية، ومعرفة الله -جل وعلا- للعبد في الشدة يعني: أن يكون معه بمعية النصر والتأييد والتوفيق وأشباه ذلك.
قال: (واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك) وهذا في القدر ومن قرأ بحثه، قال: (واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا) هذا فيه الأمر بالصبر، وأن مع الكرب يأتي الفرج، وأن مع العسر يأتي اليسر، كما قال -جل وعلا-: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا).
وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لن يغلب عسر يسرين) وهذا من فضل الله -جل وعلا- قد قال الشاعر:
اشـتدي أزمة تنفرجي ... قد آذن ليلك بالبلج
في القصيدة المسماة بـ"المنفرجة" وهذا يدل على أن العبد إذا اشتد عليه الأمر، وأحسن الصبر، وأحسن الظن بالله -جل وعلا- فإنه يؤذن له بأن ينفرج كربه، وأن ييسر له عسره، والصبر أمر به هنا في قوله: (واعلم أن النصر مع الصبر) والنصر مطلوب، فصار الصبر مطلوبا، والصبر مرتبة واجبة، وإذا حصل كرب ومصيبة، كما قال: (ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك) إذا حصلت مصيبة فإن الصبر واجب يعني: الصبر أمر الله به، وهو واجب على كل أحد، ومعنى الصبر الواجب: أن يحبس اللسان عن الشكوى، ويحبس القلب عن التسخط، ويحبس الجوارح عن التصرف بما لا يجوز من شق أو نياحة أو لطم، وأشباه ذلك من الأفعال في غير مصيبة الموت.
فإذن الصبر فيه حبس اللسان عن التشكي، كما هو تعريف الصبر، قيل للإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: هذا رجل ظلمه السلطان فأخذ يدعو عليه، قال أحمد: هذا خلاف الصبر الذي أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- مع السلطان، لا يدعى عليه.
وهذا له مأخذ آخر من جهة أن الكرب الذي ربما أتى من السلطان إذا تشكى المؤمن منه فإنه يخالف حبس اللسان عن التشكي، ولهذا لما جاء أحد الصحابة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكر له ما يلقى من المشركين من الشدة غضب النبي -عليه الصلاة والسلام- لأجل أنهم لم يصبروا، وقال: (إنه كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين ما بين جلده وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، فوالله ليتمن الله هذا الأمر. .. )الحديث، فدل هذا على أن الصبر واجب في جميع الحالات.
والصبر حبس للسان عن التشكي، وحبس للقلب عن التسخط، وحبس للجوارح عن التصرف في غير ما يرضي الله -جل وعلا-؛ ولهذا أمر الله نبيه أن يصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل، (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) وكل مخالفة لهذا الواجب يأتي لها أضدادها في حياة العبد، إما الخاصة أو العامة.
المرتبة الثانية المستحبة هي: الرضا.
الرضا بما قدر الله -جل وعلا-، فالصبر واجب، وأما الرضا فمستحب، الرضا بالمصيبة مستحب، ومعنى الرضا بالمصيبة: أن يستأنس لها، ويعلم أنها خير له، فيقول: هي خير لي، ويرضى بها في داخله، ويسلم لها، ولا يجد في قلبه تسخطا عليها، أو لا يجد في قلبه رغبة في أن لا تكون جاءته، بل يقول: الخير في هذه، وهذه مرتبة خاصة.
وهناك فرق ما بين الرضا الواجب، والرضا المستحب في المصيبة، فإن المصيبة إذا وقعت تعلق بها نوعان من الرضا: رضا واجب ورضا مستحب، والرضا الواجب هو: الرضا بفعل الله -جل وعلا-، والرضا المستحب هو: الرضا بالمصيبة، يعني: الرضا بفعل الله هذا واجب؛ لأنه لا يجوز للعبد ألا يرضى بتصرف الله -جل وعلا- في ملكوته، بل يرضى بما فعل الله -جل وعلا- في ملكوته، ولا يكون في نفسه معارضة لله -جل وعلا- في تصرفه في ملكوته، هذا القدر واجب.
وأما المستحب فهو الرضا بالمصيبة يعني: الرضا بالمقضي، فهناك فرق ما بين الرضا بالقضاء، والرضا بالمقضي، فالرضا بالقضاء الذي هو فعل الله -جل وعلا- هذا واجب، والرضا بالمقضي هذا مستحب، ونقف عند هذا، وأنبه إلى أني لن أتمكن من الحضور للدرس من يوم غد إلى ليلة الأحد، وألتقي بكم -إن شاء الله- ليلة الاثنين بإذنه تعالى، وذلك لطارئ طرأ، وسنكمل -إن شاء الله- هذا الشرح، ولو أخذنا وقتا بعد الفجر أو بعد العصر -إن شاء الله- نعدكم بإكماله، إكمال شرح هذه الأربعين.
أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد
أما بعد فهذه صله لما تقدم من شرح الأحاديث الأربعين النووية، وقد وقفنا عند الحديث العشرين.
آخر تعديل: